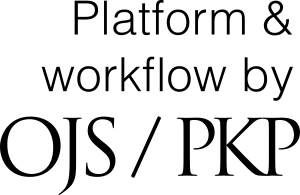تحليل الخطاب الشّعريّ قصيدة أبي البقاء الرُّندي في رثاء الأندلس (أُنْمُوذجاً)
DOI:
https://doi.org/10.51930/jcois.2018.55.333_355الملخص
" إنّ الصّورة في الشّعر ليست إلا تعبيراً عن حالة نفسية معينة يعانيها الشّاعر إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة، وإنّ أي صورة داخل العمل الفنيّ، إنّما تحمل من الإحساس، وتؤدي من الوظيفة ما تحمله وتؤدّيه الصورة الجزئية الأخرى المجاورة لها. وأنّ من مجموع هذه الصّور الجزئيّة تتألف الصّورة الكلّيّة التي تنتهي إليها القصيدة. ومعنى هذا أنّ التّجربة الشّعريّة التي يقع تحت تأثيرها الشّاعر، والتي يصدر فيها عن عملٍ فنيٍّ ليست إلا صورة كلّيّة ذات أجزاءٍ هي بدورها صور جزئيّة. ولن يتأتى لهذه الصّور الجزئيّة أن تقوم بواجبها الحقيقيّ إلا إذا تآزرت جميعها في نقل التّجربة نقلاً أميناً، ومن ثَمّ فقد وجب أن يسري فيها جميعها الأحساس نفسه، ومن هنا جاءت هيمنة الصورة أو الأحساس على العمل الفني كله، ومن هنا أيضاً لزم أن تكون الصّورة وعاء الأحساس". فالصّورة الفنّية إذن هي" الوسيلة الفاعلة التي توصلنا إلى إدراك تجربة الشّاعر، والوعاء الذّي يستوعب تلك التّجربة عن طريق السّمو باللّغة، وتفتيق طاقات الكلمة، فالصّورة تنمو داخل الشّاعر مع النّص الشّعريّ ذاته، وليست شكلاً منفصلاً؛ وعليه فإن قوة الشّعر تتمثل في الإيحاء عن طريق الصّور الشّعريّة لا في التّصريح بالأفكار مجردة ولا المبالغة في وصفها..." ولقد كانت الحالة النّفسيّة هي نقطة انطلاق الشّاعر والأديب صالح بن يزيد بن صالح... بن شريف الرُّنديّ النّفزيّ الاندلسيّ، الذي اشتهر أمره في الأندلس والمغرب، وهو واحدٌ من أدباء القرن السّابع( 601/1204ه – 684/1285م)، من أبناء رُندة، وإليها نسبته، وكان – رحمه الله - فقيها حافظاً متفنناً في النّظم والنّثر، وبرع في فنون المدح، والغزل، والوصف، والزهد، إلا أن شخصيته خلدت بقصيدته ( رثاء الأندلس) التي عُرفت بتسميّات عدّة كـ ( نونية أبي البقاء الرُّندي، ورثاء الممالك الضّائعة، ورثاء المدن الزّائلة...).
.jpg)
2.png)